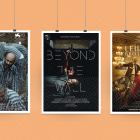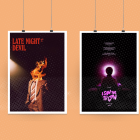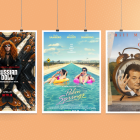فن
«اللص والكلاب» أو كما يراها الروس: لص بلا كلاب
من سعيد مهران إلى سونكا الأيدي الذهبية... كيف يتحول اللص في ذاكرة الشعوب من مجرمٍ مطارد إلى أسطورةٍ تستحق التعاطف؟
 غلاف رواية «اللص والكلاب» للأديب نجيب محفوظ باللغة العربية وغلاف نفس الرواية بالترجمة بالروسية
غلاف رواية «اللص والكلاب» للأديب نجيب محفوظ باللغة العربية وغلاف نفس الرواية بالترجمة بالروسية
رواية «اللص والكلاب» هي واحدة من أشهر أعمال نجيب لعدة أسباب، أولًا لأنها تمثل أولى الروايات في مرحلة جديدة من كتابات محفوظ التي تتسم بجزء فلسفي كبير، كما أنها تستند إلى قصة حقيقية.
تدور رواية «اللص والكلاب» حول «سعيد مهران» الذي يخرج من سجنه بعد سنوات، ليجد أن زوجته «نبوية» تزوجت صديقه «عليش»، وحتى عندما يقابل سعيد مهران ابنته فهي لا تتعرف عليه لحداثة سنّها، مما يشعل قلبه ويخطط للانتقام منهما. وهذا القلب الساخط يمتد ليشمل أشخاصًا آخرين يقابلهم مهران، ويغضب من القدر وتدبيره، ومن هذا المجتمع الظالم الذي أفقده كل شيء، بينما هؤلاء ينعمون بكل ما حرم منه. في الرواية شخصيات أخرى مثل «رؤوف علوان» الصحفي الذي يعرفه سعيد والذي انقلبت أحواله ومبادئه، والشيخ «علي الجندي» الذي يمكث عنده، ثم يهرب إلى «نور» بائعة الهوى.
إنها قصة عن العدل وماهيته، والانتقام البشري، والقلوب الغاضبة. وكما ذكرت، فالرواية اشتهرت بسبب اعتمادها على قصة «محمود أمين سليمان» في بداية الستينات، وأطلقت عليه الصحف «اللص القاتل»، حتى إنه حاز على لقب «السفاح». لكن بعد قراءتي لأخبار تلك الصحف، فتبدو القصة معقدة للغاية وذات تفاصيل كثيرة، لكن ما وصل إلى وعي الجمهور وقتها أن هذا الرجل هرب من السجن لشكه في المحامي وزوجته، وأثناء البحث عنهما ارتكب عدة جرائم، واشتعل الرأي العام وقتها بسبب أفعاله المجنونة، قبل أن تنتهي تلك المأساة بـ 17 رصاصة من الشرطة اخترقت جسده لتنتهي الأسطورة.
في الحقيقة، لا توجد العديد من المراجعات لهذه الرواية رغم أنها ترجمت في فترة مبكرة وفي حياة الكاتب، فقد صدرت الرواية بالعربية عام 1961، وترجمت بعدها إلى الروسية من قبل المترجمة إي. ستيفانوفا عام 1964، لكن لم تُنشر في طبعة منفردة بل في مجلة «عالم الأدب الأجنبي»، ولم تُنشر في كتاب إلا بعد أعوام طويلة في 1992، في كتاب يضم مختارات من ترجمات أعمال نجيب محفوظ. ورغم بحثي كثيرًا، فلم أجد نسخة أحدث بعد تلك المختارات، لذا فهي غير متوفرة ورقيًا، لكنها موجودة على الإنترنت، وهي الطريقة التي قرأها بها أغلب القراء الروس الذين ربما جذبتهم القصة، ولكن كانت هناك مشكلة.
هل يمكن لشعب أن يتعاطف وشعب آخر لا؟
كما أسلفت، فالرواية تعطي انطباعات مختلطة عن الظلم واقتراف الجرائم، فنحن نرى القتل والانتقام غير قانوني، لكن في الوقت نفسه نتعاطف مع قصة الخيانة ومع الأب الذي فجأة لم يعد أبًا، ومع الخوف من فكرة أن تتخلى عنا الدنيا فجأة فنصبح وحدنا تعساء بينما الباقون لا. تلك هي حبكة الرواية التي حيرت القراء العرب لنجيب محفوظ، وقبلها الشعب المصري كله عندما تصدّر «محمود سليمان» عناوين الصحف، فهم يرونه لصًّا حقيرًا لكن في ذات الوقت لديه كرامة، وهو ما يفهمونه، مما جعل هناك تعاطفًا لا يجب أن يُوجَّه ناحية سفاح، ولكن القصة معقدة كما أشرنا.
أما القراء الروس، فهم بعيدون كل البعد عن تلك القصة وتفاصيلها، بل لا يعرفون أنها موجودة من الأساس. لا أعلم بشأن الطبعة الأولى في المجلة، لكن النسخة في الكتاب المجمّع والنسخة الإلكترونية حاليًا لا تحوي أي إشارة أن القصة مستوحاة من لص حقيقي حيّر الشرطة، وإلا لكانت للقصة قراءات مختلفة أو أعمق، أو حتى عدد قراءات أكبر بسبب الفضول. لكن في النهاية لا توجد مقالات كثيرة ومراجعات عن الرواية، وربما فقط عُرف موضوع القصة الحقيقية في بعض الأبحاث المنشورة في المنظمات البحثية الجامعية.
نتيجة لعدم معرفتهم بهذا، فقد تعامل معها القراء الروس كقصة متخيلة فعلًا ذات حبكة أخلاقية، لكن القراء الروس كانوا أكثر تصلبًا ولم يتعاطفوا مع «سعيد مهران» اللص الذي ظلمه الجميع. لكن هل ظلمه الجميع حقًا؟
في إحدى المراجعات على موقع livelib كتب أحد القراء:
«أثناء القراءة فهمت أن البطل بعيد عن المثالية ولا يستحق التعاطف، لأن كل متاعبه تأتي من نفسه. لكن المؤلف اندمج مع شخصيته التي أراد انتصارها رغم كل شيء».
تلك رؤية مختلفة، لكن هل يمكن أن نصفها بالقاسية؟ خصوصًا أن القارئ قد أدخل نجيب محفوظ كطرف في المعادلة، ورأى أنه هو الكاتب الذي اندمج مع شخصية بطله، ولأن البطل دائمًا ما يفوز جعله يكافح حتى النهاية، حتى لو عن طريق الجرائم. وأعتقد أن هذا قد يكون صحيحًا، لكن من جانب آخر مختلف، فممكن أن يكون نجيب قد تأثر بالتعاطف الشعبي الذي شمل القصة الحقيقية مثلًا، فمعيشة أجواء الخوف وعناوين الأخبار كل يوم، والقصة التي تظهر تباعًا في الصحف بتفاصيل مختلفة تؤكد قصة الخيانة أو حتى تخلخلها، كل هذا بالتأكيد يخلق تفاعلًا مع صاحب القصة، خصوصًا أنها لم تكن مجرد خبر وحيد بقصة أحادية، بل قصة مطاردة مليئة بالتناقضات التي تميز البشر بالفعل.
إحدى القارئات على نفس الموقع ذكرت أمرًا مختلفًا حول أحد أسباب غضب ونقمة سعيد مهران، وهو عندما لم تتعرف عليه ابنته:
«بغض النظر عن عدد محاولاتي، لم أجد سمة إيجابية واحدة في البطل. إنه يفسد ليس فقط حياته، ولكن أيضًا حياة الآخرين، وكل ذلك من أجل تحقيق خططه المجنونة للانتقام. أما حبه لابنته الذي يكرره باستمرار كحجة لنفسه، لا أفهم جيدًا؟ الحب الأبوي جيد بالطبع – لكن إلقاء اللوم على طفلة صغيرة لعدم التعرف على أبيها بعد عدة سنوات من غيابه!»
هذه نقطة هامة في الحقيقة، وجعلتني أطرح سؤالًا هامًّا: إذا خرج سعيد مهران من السجن ووجد زوجته في انتظاره دون تفاصيل باقي الرواية، فهل سوف تتعرف الفتاة على والدها هذه المرة؟ في الغالب لا، لأن الطفلة لم تعرفه لأنه دخل السجن بتهمة السرقة ومكث بداخله 4 سنوات، وقصة الكبار التالية من زواج وانتقام لن تغيّر أنها لم تتذكره بسبب غياب تسبب فيه هو نفسه.
وباقي جرائم البطل التي ارتكبها في حق الآخرين غير الذين يسعى للانتقام منهم، هل هي مبررة؟ أم أن الغضب والكبرياء سبب كافٍ لحرق الكوكب؟
«كبرياء البطل يجعله يدفع ضريبة باهظة من ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم الجديدة، لكن هل تحمل أيًّا من تلك الجرائم معنى، أم أن غباء الإنسان هو العامل المشترك فيها ظنًّا منه أنه يكافح من أجل نفسه؟»
لذا من الواضح أن العديد من القراء وجدوا ثغرات في نفس سعيد مهران تدفعهم لعدم التعاطف، بل إنكار تلك الجرائم تمامًا، ليصبح هو المسؤول عنها، والمسؤول أيضًا عن قلبه واشتعاله، فحادث سيئ وخيانة من شخصين لا تعني النقمة على من هو سعيد والسعي لسرقتهم وسلبهم ما يملكون، والاندفاع في الجرائم بلا تفكير.
هذا الرأي أدى إلى جملة تكررت عدة مرات في مراجعات القراء، وتلك الجملة عن العنوان «اللص والكلاب». لقد تساءلوا لماذا الكلاب تحديدًا، وقد انقسم السؤال إلى شقين: الأول أن سعيد مهران يرى الجميع كلابًا مخطئين وخائنين، لكن هل هذا صحيح أم إنها رؤيته الشخصية المشوشة بسبب الغضب؟
كتب أحد القراء:
«اللص يدعو كل أعدائه كلابًا، فماذا يكون هو إذن؟ يمكن أن يكون هذا مفهومًا بالنسبة للذين يحملون نفوسًا منتقمة، لكنني لا أفهمه».
والشق الثاني عن الكلاب هو: لمَ الكلب أصلًا؟ الكلب عالميًا معروف بالوفاء وليس بالخيانة، وهو ما جعل القراء يتعجبون، وبعضهم فهم أنها لا بد أن تكون سُبَّة لدى العرب والمسلمين بعكس المعنى المتعارف عليه.
نبذة الرواية
أثناء بحثي عن النسخة الروسية الإلكترونية من الرواية، اصطدمت بنبذة الرواية على المواقع الروسية الخاصة بتحميل الكتب، وتلك النبذة ليست خاصة بموقع واحد، بل هي موجودة في كل مكان، وهذا يجعل من المستحيل تتبع من كتبها للمرة الأولى. وهذه النبذة مختلفة عن كل النبذات التي رأيتها، لأن تلك المواقع في الأغلب تضع الخطوط العريضة للقصة أو جملاً شيقة مثيرة تدعو للقراءة والتحميل، لكن في هذه النبذة تحليل عميق ومختلف تمامًا عن المراجعات للقراء العاديين، فكاتبها لديه خلفية واضحة عن المجتمع المصري وبعض رموزه المحتملة، وهو ما أثار استغرابي، وفكرت أن تكون تلك النبذة مترجمة من موقع عربي مثلًا، أو كُتبت من قبل باحث أو ناقد، أو حتى المترجمة الأصلية للكتاب، رغم أنني لم أجد ما يؤكد إحدى تلك النظريات.
نبذة رواية «اللص والكلاب»
«(اللص والكلاب) هي قصة بطل واحد. رُسمت الشخصيات الأخرى من قبل المؤلف بشكل أضعف من صورة البطل، وقد كانت وسائل مساعدة للكشف الكامل عن الصورة الرئيسية. ومع ذلك، هناك شخصية في القصة ذات أهمية كبيرة يجب فهم دلالتها، الشخصية هي «الشيخ علي الجندي». يرمز في القصة إلى الدين الذي لا يزال يهيمن على عقول وضمائر المصريين، حتى أولئك الذين – مثل سعيد – يعتبرون أنفسهم غير مؤمنين. جذور الدين بين الناس قوية جدًّا، وتاريخ طويل جدًّا يقف وراء أكتاف الناس مثل الشيخ علي الجندي. لقرون علّموا الناس التواضع والتسامح كونهم موصلين موثوقين للشريعة. ليس من قبيل الصدفة أن يصوّر وعي سعيد المستثار في نومه أن الشيخ علي الجندي مع أولئك الذين يديرون السلطة والعدالة في «عالم اللصوص والكلاب». من ناحية أخرى، يُظهر محفوظ بمهارة ووضوح العلاقة بين الدين والمجتمع المحتضر. وإذا كان الدين بالنسبة للأجداد والآباء مصدرًا للوحي الروحي قادرًا على توفير إجابة لجميع مشاكل الحياة المعقدة، فلن يكون بإمكان الجيل الجديد مثل سعيد الاكتفاء بمذهبه الغامض وفلسفته المطلقة البعيدة عن الواقع».
تلك القراءة واعية بالقدر الكافي لتحليل شخصية مثل «الشيخ الجندي» رغم كونها شخصية جانبية، بل واعتبارها رمزًا للدين. ومن الواضح أن الكاتب لديه خلفية جيدة عن تدين المصريين والشيوخ، وأيضًا تحليل أفعال سعيد مهران وتفكيره من جانب نفسي، وماذا يرى في الشيخ علي الجندي نتيجة لأفكاره في اللاوعي. هذا التحليل ركّز على كون الرواية كلها تتناول المجتمع وتدينه، وتأثير هذا التدين على الأبطال، وهي قراءة تكاد تكون أقرب لبحث أو دراسة من مراجعة عادية.
...
أثناء كتابة هذا الجزء، تذكرت أن للروس حكاية مشابهة مع اللصوص والأدب: قصة صوفيا إيفانوفا بلوفشتين، اللصة الشهيرة التي لا يعرف أحد ظروف نشأتها بالضبط نظرًا لكثرة تنقلها وهروبها وزيجاتها وأوراقها المزورة. في أحد السجون أشارت صوفيا، أو الاسم الذي عُرفت به «سونكا الأيدي الذهبية»، أنها وُلدت عام 1846.
لقبها بلوفشتين من زوجها الأخير، والذي كان غشاشًا معروفًا ومخادعًا في لعبة الورق. في الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر قامت سونكا بسرقات عديدة في المدن الروسية، واحتُجزت عدة مرات حتى نُفيت خارج روسيا إلى مالدوفا عام 1879، لكنها سريعًا وبعد عام قُبض عليها في وارسو بتهمة الاحتيال، وتم نفيها إلى إيركوتسك، وهربت... ثم قُبض عليها وأُرسلت إلى سجن قلعة سمولنسك، وكما هو متوقع هربت أيضًا، لكن قُبض عليها بعد أربعة أشهر وأرسلوها إلى جزيرة سخالين، واضطروا إلى تقييدها على متن السفينة المتجهة إلى هناك بعد ثلاث محاولات للهرب. وقد وصفها أنطون تشيخوف في كتاب رحلاته إلى جزيرة سخالين.
محاولات هروب «سونكا الأيدي الذهبية» لا تنتهي هنا، وقصص جرائمها الغريبة والاستعراضية التي كانت سببًا في شهرتها، إلى جانب كل تلك المطاردات، جعلت الصحف تكتب كثيرًا، بل والكتب أيضًا في تلك الفترة امتلأت بحكايتها وتحليلات لما يحدث. فقد كتب الصحفي ج. راتمير مجموعة مقالات في صحيفة «أوديسا بوست» عن سرقات «سونكا الأيدي الذهبية» وذكائها، لكن المقالات لم تكن إلا إدانة للشرطة والسخرية منهم ومن قصر نظرهم وتكرار الجرائم والهروب، ما دفع المحقق «فون لانج» الذي عمل محققًا في قسم أوديسا للرد على الصحفي بكتابين صغيرين وسماهما «الحقيقة حول الأيدي الذهبية»، والذي تتبع فيه جرائمها أيضًا وحاول تفنيد ما يقوله الصحفي حفاظًا على صورة الشرطة.
وهكذا أصبحت «سونكا» مادة للنزاع بين الصحفيين والشرطة، وكانت هي بمغامراتها مادة تنافس كتابات المحققين الخيالية التي انتشرت كثيرًا لتلك الفترة. كُتب عن «سونكا» الكثير خلال حياتها، ما جعلها باقية حتى اليوم، وذُكرت تقريبًا في كل أنواع الفن. فقد كُتب عن مغامراتها كتب، وفي عام 1915 ظهر الفيلم الصامت «سونكا الأيدي الذهبية»، وتبعه العديد من الأفلام، منهم فيلم وثائقي في 2007، حتى أن فرقة الراب «باد بالاس» قد أصدرت أغنية باسمها في 2007، بجانب أغاني أخرى عديدة للكثير من الفنانين، وهناك أكثر من مسلسل كامل باسمها. حتى اليوم ما زال المؤلفون يستخدمون شخصية «سونكا» في قصصهم، فقد استخدمها بوريس أكونين في سلسلته، بل وفي 2014 كانت «سونكا» شخصية في قصة مانجا «جولدن كاموي».
هذه الشهرة الكبيرة لشخصية «سونكا» وتناولها بشتى الأشكال الممكنة ظلت لفترة في إطار اللصة البارعة الخبيثة، لكن مع مرور الزمن ومعالجتها روائيًا وفنيًا في العديد من الأعمال، وقع الروس كما وقعنا نحن في قصة «سعيد مهران»، وبدأت شخصية جديدة تظهر، شخصية بعيدة عما ذكرتها قصص الصحف والكتب من جرائم، شخصية إنسانية مجبرة على الجريمة، وامرأة عاطفية بقصة حب عظيمة، في قصص أخرى. ووجدت أن بعض الروس تفاعلوا مع الشخصية الروائية بتعاطف لا يتناسب مع ما نشرته الصحف عنها في البداية.
إنهما بلدان بعيدان بثقافتين مختلفتين وزمنين مختلفين أيضًا، لكن موضوع اللصوص الذي يتحول إلى أساطير هو فكرة قديمة من أيام «روبن هود». وتفسيري الخاص لكلا القصتين أن البشر يريدون أن يروا بشرًا أيضًا؛ لص أو محتال أو حتى سفاح بلا سبب أو هدف هو أمر مخيف، خطر لا يمكننا التنبؤ به، لكن عندما نعلم أن هناك سببًا أو دافعًا كبيرًا مثل الكرامة والخيانة أو الحب، فهنا عقولنا تهدأ نسبيًا، بل ومع الوقت تبدأ في التعاطف مع هذا المجرم الذي لا بد أنه إنسان مثلنا بداخله الأبيض والأسود. هذا ما فعله الروس مع «سونكا الأيدي الذهبية» وما فعله محفوظ مع «سعيد مهران».